السلام عليكم ورحمة الله
لا شك أننا أبصرنا طلائع هجوم جديد وشديد على نبي الإسلام ونحن على
مشارف القرن الحادي والعشرين، وفحوى هذا الهجوم أن النبي محمد صلى الله
عليه وسلم جاء بدين يبعث على الكراهية، ويحض على العنف، ويدعو إلى الإرهاب.
فهل هذا القول حق أم أنه اعتساف يراد فرضه على الصراط المستقيم؟
حرب دفاعية
إن الإنسان السوي يكره أصحاب الغلظة والشراسة، فلو كان
أحدهم تاجرًا ما ذهبنا إلى دكانه، ولو كان موظفًا ما ذهبنا إلى ديوانه،
والمصيبة أن يُنسب هذا الاتهام إلى إمام مسجد أو داعية إلى إيمان، لكن
المصيبة العظمى أن تُنسب الغلظة والشراسة إلى نبي من أنبياء الله تعالى.
إن المتتبع لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ يجد
الرحمة تنضح منها من غير تكلف ولا اعتساف، أما الحديث الذي يروّجه البعض
ويتهم الإسلام به فله شرح تجب معرفته؛ يقول المستشرقون إن محمدًا يقول
بصريح العبارة: "نُصرت بالرعب"؛ إشارة إلى حديث "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد
من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا
وطهورًا... الحديث" رواه البخاري.
وهذا حديث صحيح، لكن الرعب المقصود هنا ليس إرهابًا ولا
عدوانًا، إنما المقصود به أن الله ناصره رغم كثرة أعدائه، ومن عوامل نصر
الله له أنه سبحانه يقذف الرعب والخوف في قلوب شياطين الإنس الذين يمثلون
جراثيم تريد الفتك بالبشرية ومسيرتها.
وهذه الكلمة جاءت في القرآن بمعنى الخوف، لا بمعنى
الهيمنة والظلم والجبروت: "فَأَتَاٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ
يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ" [الحشر: 2]
قال ابن كثير: "أي: الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه؟!".
لقد أتت الكلمة في سياق حرب دفاعية عن الحق، هجومية على
الباطل، لا عدوان فيها ولا إرهاب، فبعد هزيمة المسلمين في أحد نزل في
القرآن الكريم: "سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ"
[آل عمران - 151]
وهزيمة أحد كانت تمثل إجماعًا لقوى الشرك كلها في الجزيرة
العربية لاستئصال محمد والمؤمنين به، فشنوا هجومًا كاسحًا على محمد
وأصحابه في مدينتهم الوادعة.
وقد استطاع المشركون إيقاع خسائر كبيرة بالمسلمين وقتلوا
عددًا كبيرًا من حفاظ القرآن الكريم، مما ترك آثارًا في النفوس، فأراد
الله أن يواسي المؤمنين المظلومين، وأن يشعرهم أن المرحلة القادمة ستكون
لمصلحتهم، وأنه سيلقي الرعب في قلوب المعتدين مهما تكاثروا وتنمّروا.
إن تحريف الكلم عن موضعه شيء مألوف عند أعداء محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التمحيص لا نجد لتلك التهم أثرًا في سيرته.
بُعثت رحمة
ويخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من معركة أحد جريحًا
قد كُسرت رباعيته، وشُج وجهه، فيقول له بعض الصحابة رضي الله عنهم: لو
دعوت عليهم يا رسول الله؟ فيقول: "إني لم أُبعث لعانًا، ولكني بُعثت رحمة
للعالمين، اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون"، وهكذا قال يوم فتح مكة:
"اذهبوا فأنتم الطلقاء"، ورأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فغضب، وقال:
"ألم أنهكم عن قتل النساء؟! ما كانت هذه لتقاتل".
وفي يوم فتح مكة أيضًا، جاء عمير بن وهب إلى الرسول محمد
صلى الله عليه وسلم وشفع لصاحبه وابن عمه صفوان بن أمية -وكان صفوان من
ألد أعداء الإسلام- وقال عمير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا نبي
الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه قد خرج هاربًا منك؛ ليقذف بنفسه في البحر
فأمّنه -أي أعطه الأمان- فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "قد أمّنته"
فقال عمير: يا رسول الله أعطني آية -علامة- يعرف بها أمانك، فأعطاه الرسول
عمامته التي دخل بها مكة!.
فخرج عمير بها حتى أدرك صفوان وهو يريد أن يركب البحر،
فقال: يا صفوان فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان
رسول الله قد جئتك به، فقال له صفوان: ويحك، اغرب عني فلا تكلمني، فقال
عمير: أي صفوان، فداك أبي وأمي، إن رسول الله أفضل الناس، وأبر الناس،
وأحلم الناس، عِزُّهُ عزُّك، وشرفُه شرفُك، فقال صفوان: إني أخاف على
نفسي، فقال عمير: هو أحلم من ذاك وأكرم.
فرجع معه وذهبا إلى رسول الله محمد فقال صفوان للنبي صلى
الله عليه وسلم: "إن هذا يزعم أنك قد أمنتني؟ فقال الرسول محمد صلى الله
عليه وسلم: "صدق"، فقال صفوان: فاجعلني فيه -أي في الإيمان- بالخيار
شهرين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "بل لك تسير أربعة أشهر".
ملأ الحب قلبه
الشاهد الأعظم في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه
لم يكن عدوانيًّا ولا منتقمًا ولا مرعبًا، إنما كان الذي يملأ قلبه، هو حب
الخير والهدى للناس.
إن النبي المنتصر صلى الله عليه وسلم -والذي دانت له
الجزيرة العربية- لم يكن طالب ثأر ولا منتقمًا من أحد، لقد كانت الرغبة
المستولية على مشاعره الرقيقة أن يفتح أقفال العقول والقلوب، وأن ينقذ
التائهين الحيارى؛ لذا كان يَلقى العدوان بالعفو، ويقابل السيئة بالحسنة،
فلا تقر عيناه إلا برؤية الناس داخلين في دين الحق الذي جاء به.
إنه رسول يريد قيادة العباد إلى ربهم بالحسنى، وليس بشرًا
شهوانيًّا ينزع إلى القهر والتسلط والانتقام، فسيرته تؤكد أنه ما انتقم
لنفسه قط، ولا طلب لها علوًّا في الأرض، ولا قهر أحدًا وأكرهه على الدخول
في دينه.
لقد كان أسلوبه في التربية وتعهد الأتباع هو غرس الرحمة
فيهم، وإشعاع مشاعر الحب في الله بينهم، فقد وضع النبي محمد صلى الله عليه
وسلم جملة مبادئ توحد النفس التائهة، وتجمع الشمل المتفرق، وتوضح الهدف
الغائم، وتعود بالناس إلى الرحمة التي فقدوها، وتتناول ما عراهم من أسباب
التناحر والتصارع والكراهية.
لقد كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: "ارحموا تُرحموا"
أخرجه الإمام أحمد، وكان يقول معلمًا ومرشدًا صلى الله عليه وسلم:
"الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" أخرجه
أبو داود والترمذي، ويقول أيضًا صلى الله عليه وسلم: "من لا يَرحم لا
يُرحم" أخرجه البخاري ومسلم.
وليس المقصود بالرحمة رحمة الإنسان فقط، بل الرحمة لكل الخلق، ففي شرح الحديث قال ابن بطال:
"فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن
والكافر والبهائم -المملوك منها وغير المملوك- ويدخل في الرحمة التعاهد
بالإطعام والسقي، والتخفيف في الحمل، وترك التعدي بالضرب!".
أخوة وتراحم
إن الإسلام مذ بدأت مسيرته لم يعرف الغلظة والاستكبار،
ولم يعرف حرب الأجناس ولا تعصبات الأعراق، لقد جاء النبي محمد صلى الله
عليه وسلم بصيغة تسوي بين كل الأجناس، فهم أبناء آدم وحواء، وقال إن أهل
الشرق لا يتفضلون على أهل الغرب، فالعربي لا يتفضل على الأعجمي، والأعجمي
لا يتفضل على العربي إلا بالعمل الصالح والتقوى، جاء في خطبة الوداع في
يوم الحج -وهو يوم يجتمع فيه المسلمون من كل مكان في الأرض- وأمام جماهير
المسلمين قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم:
"يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا
لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا
أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلّغت؟ قالوا: بلّغ رسول الله صلى الله
عليه وسلم".
هذه المعالم تربّى عليها المسلمون الأوائل، وعندما
استطاعوا فتح العالم - والهيمنة على أزمّة الأمور فيه- ما اعتزوا بعنصر
ولا لون ولا دم، بل كانوا أبعد الناس عن تلك المهاترات، كانوا ينشرون
الأخوة والتراحم بين الناس، وكانت رسالتهم إيصال هذا الوحي إلى البشر كافة
دون امتياز أو منزلة خاصة بهم؛ فدينهم علّمهم أن منزلة كل إنسان بمدى عمله
وبلائه ووفائه؛ لذا كانوا يرحّبون بكل داخل في الدين الجديد ويقدمونه على
أنفسهم، وشواهد التاريخ كثيرة في هذا الشأن.
إن الإسلام -كالعِلم- لا وطن له، فلا عنصر يحتكره، ولا
أرض تحدّه، فوطنه الفسيح هو العقل الحر، والقلب الإنساني الكريم؛ لذا كانت
الدعوة الجديدة رحمة جديدة تغمر الأرض كلها، وليست إرهابًا نازلاً من
السماء.
لا شك أننا أبصرنا طلائع هجوم جديد وشديد على نبي الإسلام ونحن على
مشارف القرن الحادي والعشرين، وفحوى هذا الهجوم أن النبي محمد صلى الله
عليه وسلم جاء بدين يبعث على الكراهية، ويحض على العنف، ويدعو إلى الإرهاب.
فهل هذا القول حق أم أنه اعتساف يراد فرضه على الصراط المستقيم؟
حرب دفاعية
إن الإنسان السوي يكره أصحاب الغلظة والشراسة، فلو كان
أحدهم تاجرًا ما ذهبنا إلى دكانه، ولو كان موظفًا ما ذهبنا إلى ديوانه،
والمصيبة أن يُنسب هذا الاتهام إلى إمام مسجد أو داعية إلى إيمان، لكن
المصيبة العظمى أن تُنسب الغلظة والشراسة إلى نبي من أنبياء الله تعالى.
إن المتتبع لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ يجد
الرحمة تنضح منها من غير تكلف ولا اعتساف، أما الحديث الذي يروّجه البعض
ويتهم الإسلام به فله شرح تجب معرفته؛ يقول المستشرقون إن محمدًا يقول
بصريح العبارة: "نُصرت بالرعب"؛ إشارة إلى حديث "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد
من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا
وطهورًا... الحديث" رواه البخاري.
وهذا حديث صحيح، لكن الرعب المقصود هنا ليس إرهابًا ولا
عدوانًا، إنما المقصود به أن الله ناصره رغم كثرة أعدائه، ومن عوامل نصر
الله له أنه سبحانه يقذف الرعب والخوف في قلوب شياطين الإنس الذين يمثلون
جراثيم تريد الفتك بالبشرية ومسيرتها.
وهذه الكلمة جاءت في القرآن بمعنى الخوف، لا بمعنى
الهيمنة والظلم والجبروت: "فَأَتَاٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ
يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ" [الحشر: 2]
قال ابن كثير: "أي: الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه؟!".
لقد أتت الكلمة في سياق حرب دفاعية عن الحق، هجومية على
الباطل، لا عدوان فيها ولا إرهاب، فبعد هزيمة المسلمين في أحد نزل في
القرآن الكريم: "سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ"
[آل عمران - 151]
وهزيمة أحد كانت تمثل إجماعًا لقوى الشرك كلها في الجزيرة
العربية لاستئصال محمد والمؤمنين به، فشنوا هجومًا كاسحًا على محمد
وأصحابه في مدينتهم الوادعة.
وقد استطاع المشركون إيقاع خسائر كبيرة بالمسلمين وقتلوا
عددًا كبيرًا من حفاظ القرآن الكريم، مما ترك آثارًا في النفوس، فأراد
الله أن يواسي المؤمنين المظلومين، وأن يشعرهم أن المرحلة القادمة ستكون
لمصلحتهم، وأنه سيلقي الرعب في قلوب المعتدين مهما تكاثروا وتنمّروا.
إن تحريف الكلم عن موضعه شيء مألوف عند أعداء محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التمحيص لا نجد لتلك التهم أثرًا في سيرته.
بُعثت رحمة
ويخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من معركة أحد جريحًا
قد كُسرت رباعيته، وشُج وجهه، فيقول له بعض الصحابة رضي الله عنهم: لو
دعوت عليهم يا رسول الله؟ فيقول: "إني لم أُبعث لعانًا، ولكني بُعثت رحمة
للعالمين، اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون"، وهكذا قال يوم فتح مكة:
"اذهبوا فأنتم الطلقاء"، ورأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فغضب، وقال:
"ألم أنهكم عن قتل النساء؟! ما كانت هذه لتقاتل".
وفي يوم فتح مكة أيضًا، جاء عمير بن وهب إلى الرسول محمد
صلى الله عليه وسلم وشفع لصاحبه وابن عمه صفوان بن أمية -وكان صفوان من
ألد أعداء الإسلام- وقال عمير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا نبي
الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه قد خرج هاربًا منك؛ ليقذف بنفسه في البحر
فأمّنه -أي أعطه الأمان- فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "قد أمّنته"
فقال عمير: يا رسول الله أعطني آية -علامة- يعرف بها أمانك، فأعطاه الرسول
عمامته التي دخل بها مكة!.
فخرج عمير بها حتى أدرك صفوان وهو يريد أن يركب البحر،
فقال: يا صفوان فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان
رسول الله قد جئتك به، فقال له صفوان: ويحك، اغرب عني فلا تكلمني، فقال
عمير: أي صفوان، فداك أبي وأمي، إن رسول الله أفضل الناس، وأبر الناس،
وأحلم الناس، عِزُّهُ عزُّك، وشرفُه شرفُك، فقال صفوان: إني أخاف على
نفسي، فقال عمير: هو أحلم من ذاك وأكرم.
فرجع معه وذهبا إلى رسول الله محمد فقال صفوان للنبي صلى
الله عليه وسلم: "إن هذا يزعم أنك قد أمنتني؟ فقال الرسول محمد صلى الله
عليه وسلم: "صدق"، فقال صفوان: فاجعلني فيه -أي في الإيمان- بالخيار
شهرين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "بل لك تسير أربعة أشهر".
ملأ الحب قلبه
الشاهد الأعظم في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه
لم يكن عدوانيًّا ولا منتقمًا ولا مرعبًا، إنما كان الذي يملأ قلبه، هو حب
الخير والهدى للناس.
إن النبي المنتصر صلى الله عليه وسلم -والذي دانت له
الجزيرة العربية- لم يكن طالب ثأر ولا منتقمًا من أحد، لقد كانت الرغبة
المستولية على مشاعره الرقيقة أن يفتح أقفال العقول والقلوب، وأن ينقذ
التائهين الحيارى؛ لذا كان يَلقى العدوان بالعفو، ويقابل السيئة بالحسنة،
فلا تقر عيناه إلا برؤية الناس داخلين في دين الحق الذي جاء به.
إنه رسول يريد قيادة العباد إلى ربهم بالحسنى، وليس بشرًا
شهوانيًّا ينزع إلى القهر والتسلط والانتقام، فسيرته تؤكد أنه ما انتقم
لنفسه قط، ولا طلب لها علوًّا في الأرض، ولا قهر أحدًا وأكرهه على الدخول
في دينه.
لقد كان أسلوبه في التربية وتعهد الأتباع هو غرس الرحمة
فيهم، وإشعاع مشاعر الحب في الله بينهم، فقد وضع النبي محمد صلى الله عليه
وسلم جملة مبادئ توحد النفس التائهة، وتجمع الشمل المتفرق، وتوضح الهدف
الغائم، وتعود بالناس إلى الرحمة التي فقدوها، وتتناول ما عراهم من أسباب
التناحر والتصارع والكراهية.
لقد كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: "ارحموا تُرحموا"
أخرجه الإمام أحمد، وكان يقول معلمًا ومرشدًا صلى الله عليه وسلم:
"الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" أخرجه
أبو داود والترمذي، ويقول أيضًا صلى الله عليه وسلم: "من لا يَرحم لا
يُرحم" أخرجه البخاري ومسلم.
وليس المقصود بالرحمة رحمة الإنسان فقط، بل الرحمة لكل الخلق، ففي شرح الحديث قال ابن بطال:
"فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن
والكافر والبهائم -المملوك منها وغير المملوك- ويدخل في الرحمة التعاهد
بالإطعام والسقي، والتخفيف في الحمل، وترك التعدي بالضرب!".
أخوة وتراحم
إن الإسلام مذ بدأت مسيرته لم يعرف الغلظة والاستكبار،
ولم يعرف حرب الأجناس ولا تعصبات الأعراق، لقد جاء النبي محمد صلى الله
عليه وسلم بصيغة تسوي بين كل الأجناس، فهم أبناء آدم وحواء، وقال إن أهل
الشرق لا يتفضلون على أهل الغرب، فالعربي لا يتفضل على الأعجمي، والأعجمي
لا يتفضل على العربي إلا بالعمل الصالح والتقوى، جاء في خطبة الوداع في
يوم الحج -وهو يوم يجتمع فيه المسلمون من كل مكان في الأرض- وأمام جماهير
المسلمين قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم:
"يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا
لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا
أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلّغت؟ قالوا: بلّغ رسول الله صلى الله
عليه وسلم".
هذه المعالم تربّى عليها المسلمون الأوائل، وعندما
استطاعوا فتح العالم - والهيمنة على أزمّة الأمور فيه- ما اعتزوا بعنصر
ولا لون ولا دم، بل كانوا أبعد الناس عن تلك المهاترات، كانوا ينشرون
الأخوة والتراحم بين الناس، وكانت رسالتهم إيصال هذا الوحي إلى البشر كافة
دون امتياز أو منزلة خاصة بهم؛ فدينهم علّمهم أن منزلة كل إنسان بمدى عمله
وبلائه ووفائه؛ لذا كانوا يرحّبون بكل داخل في الدين الجديد ويقدمونه على
أنفسهم، وشواهد التاريخ كثيرة في هذا الشأن.
إن الإسلام -كالعِلم- لا وطن له، فلا عنصر يحتكره، ولا
أرض تحدّه، فوطنه الفسيح هو العقل الحر، والقلب الإنساني الكريم؛ لذا كانت
الدعوة الجديدة رحمة جديدة تغمر الأرض كلها، وليست إرهابًا نازلاً من
السماء.

 الرئيسية
الرئيسية


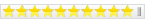
 ^مًسُاهمَتي **
^مًسُاهمَتي ** ♣ نقاطي » *
♣ نقاطي » * ♣ التقيم» *
♣ التقيم» *
